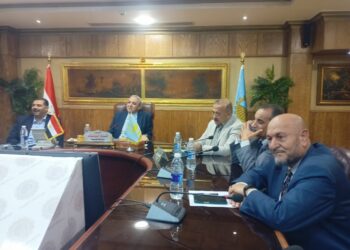شبهات وردود (8)
إذا كان القراّن وحياً من الله فلماذا هذا التناقض؟
أ. د. محمد العربي
الشبهة: جاء فى سورة النساء: (أفلا يتدبرون القراّن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً
كثيرا).
ولكنا نجد فيه التناقض الكثير مثل:
| كلام الله لا يتبدل | كلام الله يتبدل |
| ( لا تبديل لكلمات الله ) | ( وإذا بدلنا أية مكان أية ) |
| ( لا مبدل لكلماته ) | ( ما ننسخ من أية أو ننسها نأت بخير منها ) |
| ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) | ( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) |
هذه طريقتهم فى عرض هذه الشبهة يقابلون بين بعض الآيات على اعتبار تصورهم، وهو أن كل آية تناقض معنى الآية المقابله لها، على غرار ما ترى فى هذا الجدول الذى وضعوه لبيان التناقض فى القراّن حسب زعمهم.
الرد على الشبهة:
الصورة الأولى للتناقض الموهوم بين آية يونس: ( لا تبديل لكلمات الله ) وآية النحل: ( وإذا بدلنا آية مكان أية ) لا وجود لها إلا في أوهامهم ويبدو أنهم يجهلون معنى التناقض تماماً ، فالتناقض من أحكام العقل ، ويكون بين أمرين كليين لا يجتمعان أبدا في الوجود في محل واحد ولا يرتفعان أبداً عن ذلك المحل ، بل لابد من وجود أحدهما وانتفاء الأخر، مثل الموت والحياة فالإنسان يكون اما حياً وإما میتا ، ولا يرتفعان عنه في وقت واحد ، ومحال أن يكون حيا وميتاً فى آن واحد ؛ لأن النقيضين لا يجتمعان في محل واحد .
ومحال أن يكون إنسان ما لا حي ولا ميت في آن واحد وليس في القراّن کله صورة ما من صور التناقض العقلي إلا ما يدعيه الجهلاء أو المعاندون والعثور على التناقض بين الآيتين المشار إليهما محال محال ، لأن قوله تعالى في سورة يونس: ( لا تبديل لكلمات الله ) معناه: لا تبديل لقضاء الله الذي يقضيه في شئون الكائنات ، ويتسع معنى التبديل هنا ليشمل سنن الله وقوانينه الكونية ، ومنها القوانين الكيميائية ، والفيزيائية وما ينتج عنها من تفاعلات بين عناصر الموجودات أو تغييرات تطرأ عليها، كتسخين الحديد أو المعادن وتمددها بالحرارة، وتجمدها وانكماشها بالبرودة، هذه هي كلمات الله عز وجل.
وقد عبَّر عنها القرآن في مواضع أخرى بـ(السنن) وهي القوانين التي تخضع لها جميع الكائنات؛ الإنسان والحيوان والنبات والجمادات. وكل شئ في الوجود ، يجري ويتفاعل وفق السنن الإلهية أو كلماته الكلية ، التي ليس في مقدور قوة في الوجود أن تغيرها أو تعطل مفعولها في الكون.
ذالك هو المقصود به بـ ” كلمات الله ” التى لا نجد لها تبديلاً ولا نجد لها تحويلاً .
ومن هذه الكلمات أو القوانين والسنن الإلهية النافذة طوعاً أو كرهاً قوله تعالى: ( كل نفس ذائقة الموت ) فهل فى مقدور أحد مهما كان أن يعطل هذه السنة الإلهية فيوقف “سيف المنايا” ويهب كل الأحياء خلودا فى هذه الحياه الدنيا؟
فكلمات الله إذن هي عبارة عن قضائه فى الكائنات وقوانينه المطردة فى الموجودات وسننه النافذة فى المخلوقات.
ولا تناقض فى العقل ولا فى النقل ولا فى الواقع المحسوس بين مدلول آيه : ( لا تبديل لكلمات الله ) وآية ( واذا بدلنا آية مكان اّية ).
لأن معنى هذه الآية: إذا رفعنا آية أى أوقفنا الحكم بها ، ووضعنا آية مكانها ، أى وضعنا الحكم بمضمونها مكان الحكم بمضمون الأولى ، قال جهلة المشركين : إنما أنت مفتر.
فلكل من الآيتين معني في محل غير معنی ومحل الأخرى، فالآية في سورة يونس: ( لا تبديل لكلمات الله ) والآية في سورة النحل: ( وإذا بدلنا آية مكان آية ) لكل منهما مقام خاص، ولكن هؤلاء الحقدة جعلوا الكلمات بمعنى الآيات، أو جعلوا الآيات بمعنى الكلمات زوراً وبهتانًا، ليوهموا الناس أن في القرآن تناقضاً ، وهيهات هيهات لما يتوهمون.
أما الآيتان: ( لا مبدل لكلماته ) و ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ) وقد تقدم ذكرهما في الجدول السابق؛ هاتان الآيتان بريئتان من التناقض براءة قرص الشمس من اللون الأسود: فآية الكهف: ( لا مبدل لكلماته ) معناها لا مغير لسننه وقوانينه فى الكائنات وهذا هو ما عليه المحققون من أهل العلم ويؤيده الواقع المحسوس والعلم المدروس.
وحتى لو كان المراد من ” كلماته ” آياته المنزلة فى الكتاب العزيز “القراّن” فإنه كذلك لا مبدل لها من الخلق فهي باقية محفوظه كما أنزلها الله عز وجل، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
أما آية البقرة: ( ما ننسخ من آية ) فالمراد من الآية فيها: المعجزة التي يجريها الله على أيدي رسله ، ونسخها يعني رفعها بعد وقوعها، وليس المراد الآية من القراّن، وهذا ما عليه المحققون من أهل التأويل، بدليل قوله تعالى فى نفس الآية: ( ألم تعلم أن الله على كل شئ قدير). ويكون الله عز وجل قد أخبر عباده عن تأييده رسله بالمعجزات وتتابع تلك المعجزات؛ لأنها من صنع الله ، والله على كل شئ قدير.
فالآيتان كما تری لكل منهما مقام خاص وليس بينهما أدنى تعارض، فضلاً عن أن يكون بينهما تناقض.
أما الآيتان الأخيرتان الواردتان في الجدول، وهما آية الحجر: ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) وآية الرعد: ( يمحو الله ما يشاء ويثبت( فلا تعارض بينهما كذلك، لأن الآية الأولى إخبار من الله بأنه حافظ للقرآن من التبديل والتحريف والتغيير، ومن كل آفات الضياع وقد صدق إخباره تعالى، فظل القرآن محفوظاً من كل ما يمسه مما مس كتب الرسل السابقين عليه في الوجود الزمني، ومن أشهرها التوراة وملحقاتها والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام.
أما الآية الثانية: ( يمحو الله ما يشاء ويثبت ) فهي إخبار من الله بأنه هو وحده المتصرف فى شؤون العباد دون أن يحد من تصرفه أحد، فإرادته ماضية، وقضاؤه نافذ، يحيي ويميت، يغنی ويفقر، يصح ويمرض، يسعد ويشقى، يعطى ويمنع، لا راد لقضائه، ولا معقب على حكمه: ( لا يسأل عما يفعل وهم يسالون ) فأين التناقض المزعوم بين هاتين الآيتين يا ترى؟
التناقض كان سيكون لو ألغت آية معنى الأخري، أما ومعنى الآيتين كل منهما يسير في طريق متواز غير طريق الأخري، فإن القول بوجود تناقض بينهما ضرب من الخيال والهذيان المحموم، ولكن ماذا نقول حينما يتكلم الحقد والحسد، ويتوارى العقل وراء دياجير الجهالة الحاقدة؟ نكتفي بهذا الرد الموجز المفحم، على ما ورد في الجدول المتقدم ذکره.
وهنالك شبه أخرى يمكن سردها بإيجاز:
1- إنهم توهموا تناقضاً بين قوله تعالى: (يدبر الأمر من السماء إالى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون) ومن قوله تعالى: (تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) وفي عبارة شديدة الإيجاز ترد على هذه الشبهة الفرعية التى تصيدوها من اختلاف زمن العروج إلى السماء، فهو في آية السجدة ألف سنة وهو في آية المعارج خمسون ألف سنة، ومع هذا الفارق العظيم فإن الآيتين خاليتان من التناقض.. لماذا؟ لأنهما عروجان وعارجان .
فالعارج فى اّية السجدة الأمر، والعروج عروج الأمر، والعارج فى اّية المعارج هم الملائكة والعروج هو عروج الملائكة.
اختلف العارج والعروج فى الاّيتين، فاختلف الزمن فيها قصراً أو طولاً، وشرط التناقض لو كانوا يعلمون هو اتحاد المقام.
2- وقالوا أيضاً: إن في القرآن آية تنهي عن النفاق. وآية أخرى تكره الناس علي النفاق. أما الآية الأولي التي تنهي عن النفاق –عندهم- فهي قوله تعالى: (وبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما). وأما الآية التي تكره الناس علي النفاق –عندهم- فهي قوله تعالى: ( وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله اّنى يؤفكون ).
ونقول: من المحال أن يفهم من له أدنی حظ من عقل أو تمييز أن في الآية الأولى نهياً، وأن فى الاّية الثانية إكراهاً ، ويبدو بكل وضوح أن مثیری هذه الشبهات في أشد الحاجة إلى من يعلمهم القراءة والكتابة على منهج: وزن وخزن وزرع .
ويبدو بكل وضوح أنهم أعجميو اللسان، لا يجيدون إلا الرطانة و التهتهة ؛ لأنهم جهلة باللغة العربية ، لغة التنزيل المعجز، ومع هذه المخازى ينصبون أنفسهم لنقد القرآن، الذي أعجز الإنس والجن.
لا نهى في الآية الأولى ، لأن النهي في لغة التنزيل له أسلوب لغوی معروف ، هو دخول ” لا ” الناهية على الفعل المضارع مثل : لا تفعل کذا ، ويقوم مقامه أسلوب آخر هو : إياك أن تفعل ، جامعا بين التحذير والنهي ، ولا إكراه في الآية الثانية ، وإن جهل هؤلاء الحقدة أن الإکراه من صفات الأفعال لا من صفات الأقوال. أما كان أحرى بهم أن يستحيوا من ارتكاب هذه الحماقات الفاضحة؟
إن الآية الأولى : ( وبشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً ) تحمل إنذاراً ووعيدا ، أما النهي فلا وجود له فيها والأية الثانية تسجل عن طريق ” الخبر ” انحراف اليهود والنصارى في العقيدة ، وكفرهم بعقيدة التوحيد ، وهى الأساس الذي قامت عليه رسالات الله عز وجل.
وليس في هذه الآية نفاق أصلاً ، ولكن فيها رمز إلى أن اليهود والنصارى حين نسبوا “الابنية” لله لم يكونوا على ثقة بما يقولون، ومع هذا فإنهم ظلوا في خداع أنفسهم.
وكيف يكون القرآن قد أكرههم على هذا النفاق “المودرن” وهو في الوقت نفسه يدعو عليهم بالهلاك بقبح إشراكهم بالله: ( قاتلهم الله )؟