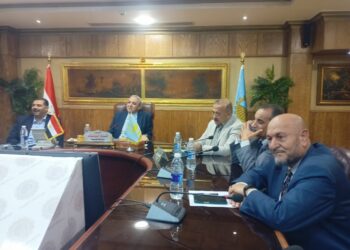بقلم: أ.د/ محمد عبدالدايم الجندى
وكيل كلية الدعوة الاسلامية جامعة الازهر الشريف بالقاهرة
حين يدفع غربي شبهة بني جلدته ومريديهم حول سيدنا الرسول الأعظم؛ تكون النتيجة المنطقية تسليم المتجاوزين وإلقاء أقلامهم وقراطيسهم مذعنين لرسول الله ولرسالته، ولم تحظ شخصية في تاريخ البشرية العريض بالاهتمام والإشادة والذب مثل ما حظيت شخصية النبي الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وها نحن بين يدي كلمات ” ول ديورانت ” لنرد قسطا من هذه الكلمات التي تثلج الصدور، وتشعرنا عند تلاوتها بالفخار، وفيما يأتي نعرض لنسائم من شهاداته ودفاعاته عن رسولنا الكريم .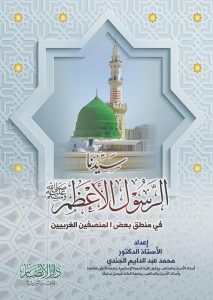
ـ ثناء ” ول ديورانت ” على منبت وهيئة النبي صلى الله عليه وسلم: تناغمت عبارات ” ول ديورانت ” مع إنصافة حين كتب عن غرس النبي صلى الله عليه وسلم الذي نشأ فيه، والتكوين المليء بالعناية، وقد راع الغرب لمعة مقاله حتى اقتُنص بحبائل إنصافه حين أسس لمنابته صلى الله عليه وسلم على أسس؛ الأساس الأول: أسرته، فيقول عنها: “لقد كان محمد من أسرة كريمة ممتازة”، والأساس الثاني: اسمه، حيث حلله تحليلا لغويا يرجع إليه بالمحامد صلى الله عليه وسلم قائلا: ” ولفظ “محمد” مشتق من الحمد وهو مبالغة فيه، كأنه حمد مرة بعد مرة، ويمكن أن تنطبق عليه بعض فقرات في التوراة تبشر به “.
ويبدو في كلمات ” ول ديورانت ” إنصاف جلي وبراعة استهلال، وثناء متضمن في سياق التحليل اللغوي لمسماه صلى الله عليه وسلم ، وقد أحسن في هذا الثناء ” فمحمد اسم علم، وهو منقول من صفة من قولهم “رجل محمد” وهو الكثير الخصال المحمودة، والمحمد في لغة العرب هو الذي يحمد حمدا بعد حمد مرة بعد مرة ، وقد اختار الله هذا الاسم الطيب لنبيه محمد، فهو الحامد لربه، المحمد من عباده؛ حمد ربه على ما أفاء عليه من الفضل، وحمده الناس بما جاءهم به من الحق، فهو حامد لله ” محمد “، محمود من الله ومن الناس ” .
وإن ورود ” ول ديورانت ” لطريق التحليل اللغوي؛ دفاع ممزوج بالتقدير والاعتزاز، وهو يلاقي صدى واسعا، سيما أنه من كبار مفكري الغرب وأعمدة الفلسفة فيه، ويعد طريق لمواجهة خصوم الإسلام ونبي المرحمة، وإسكات لكل رديء في فطرته، أو خبيث في طويته مولع بالسوء، متهافت على المنكر، في وقت هاجت فيه عاصفة من الهرطقة الشرسة من الهجوم على الإسلام ” فقد كان الإسلام في نظر الغرب حتى بداية الحرب العالمية الثانية بمثابة المتهم الذي يطلب منه أن يثبت براءته من تهم ألصقت به، أما خلال النصف الثاني من القرن العشرين، واجه الغرب تحديا عجز عن تفسيره، فبعض المفكرين الغربيين كانوا أقوى من أن يستبد بهم التعصب التقليدي ضد الإسلام، فأقبلوا عليه درسا وتمحيصا وتأملا “، وكان من بينهم شاهدنا على عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ” ول ديورانت “، الذي تألق في ثوب الإنصاف، ويتجلى إنصافه في الأساس الثالث وهو: تكوينه وطبعه صلى الله عليه وسلم : يقول :” وكان محمد مهيب الطلعة، لا يضحك إلا قليلاً، قادراً على الفكاهة ولكنه لا يترك العنان لهذه الموهبة، لأنه كان يعرف خطورة المزاح إذا نطق به من يتولى أمور الناس، وكان مرهف الحس سريع التأثر، ميالاً إلى الانقباض كثير التفكير، كان إذا غضب أو تهيج انتفخت عروق وجهه، ولكنه كان يعرف متى يهدأ من انفعاله، وكان في وسعه أن يعفو من فوره عن عدوه الأعزل إذا تاب”، وهذه الصورة التي رسمها ” ول ديورانت ” لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم تقفز إلى الخواطر كلما واجهت الأمة عدوانا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهي لا تستطيع حتى أن تتألم ، ومثل كلام “ول ديورانت” يشعرنا بشيء من الرمق عند المواجهة في ظل العجز والشلل الذي أصاب أعضاء الحركة في أمتنا المسلمة في وقت كثر فيه طنين ذباب الغرب بقاذوراته ليدور بها حول هالات الطهر والنقاء.
محمد صلى الله عليه وسلم أعظم عظماء التاريخ : استشعر “ول ديورانت” عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وقفزت إلى ذهنه تلك العظمة ناصعة البياض، فرغم كفره لم يحل ركام فساد عقيدته دون إنصافه، فراح يبتهل شهادته، وانسابت من فؤاده مشاعر مملوءة بالحقيقة، وفاحت روائحها في مدارس الاستشراق وهي تهتف بعظمة محمد، ومن كلامه : “إذا ما حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس قلنا إن محمدًا صلى الله عليه وسلم كان من أعظم عظماء التاريخ، فلقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به في دياجير الهمجية حرارة الجو وجدب الصحراء، وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاحًا لم يدانه فيه أي مصلح آخر في التاريخ كله، وقلّ أن نجد إنسانًا غيره حقق ما كان يحلم به.. ولم يكن ذلك لأنه هو نفسه كان شديد التمسك بالدين وكفى، بل لأنه لم يكن ثمة قوة غير قوة الدين تدفع العرب في أيامه إلى سلوك ذلك الطريق الذي سلكوه “.
ولا شك أن المجتمع الجاهلي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعج بالجاهليات والأوثان وألوان الشرك التي كانت تموج بألوان من الظلام الدامس إلى أن جاء السراج المنير ممزقا تلك الكثف الظلامية، جاء في كتاب حكم محمد للأديب الروسي ” تولستوي “: ” كان العرب قبل ظهور الرسول يعبدون آلهة متعددة، وأرواحا صالحة وشريرة، وكانت هذه الآلهة على قسمين: عائلية ووطنية، فكان كثير من العائلات تصنع لها صنما خاصا تعبده، وكان في كل قبيلة صنم عام تعبده “.
وإنني أعتقد أن كلمات “ول ديورانت” ـ السابقة ـ مليئة بالتنوير الذي يركض خلف شبهات الغرب ضد النبي صلى الله عليه وسلم ليعطل قوامها ، وبفضل كتاباته تغيرت صورة النبي صلى الله عليه وسلم عند المثقفين في الغرب، ” فالتفكير المنطقي موجود في الغرب إلا أن القيم والمعايير مختلفة ، والولاءات متعددة ، يقول أحد المستشرقين: “إننا كأوروبيين نشعر بتحمل جزء من المسئولية في موضع ما؛ يرتبط بتأسيس دولة إسرائيل وكذلك بالاستعمار، وهناك عدد وفير من الصراعات المتشابكة بيننا وبين الإسلام يصعب تنظيمها، وهي تثير لدينا إحساسا بالفتنة والإعجاب “.
إذن هناك أزمة نفسية وعقدة فكرية لدى الغرب رغم معرفة أكثرهم للحقيقة ، ولكن يبقى المنصفون أمثال “ول ديورانت” ليبرزوا عظمة الإسلام ونبيه رغم أنف كل أبي جهل على مر الزمان ، يقول الدكتور عبد الودود شلبي: “وموقف الغرب من الإسلام ونبيه هو موقف أبي جهل، إنهم يعرفون الحقيقة كاملة عن النبي وعن الإسلام غير أنهم لا يملكون شجاعة أبي جهل في الاعتراف بالحق “.
لقد واجه “ول ديورانت” بكل صراحة كل من هرطق في شأن مقام رسول الله، أو اتهمه بالرجعية والتخلف، مبينا أن الحضارة إنما برزت من رسالة محمد القوية بذاتها، والتي لاحقت الخرافة واغتالت سلطانها ، حيث تفشت قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم مظاهر التخلف والرجعية بأخلاقها الرذيلة، يقول ” ول ديورانت ” :”كانت بلاد العرب لما بدأ الدعوة صحراء جدباء، تسكنها قبائل من عبدة الأوثان قليل عددها، متفرقة كلمتها، وكانت عند وفاته أمة موحدة متماسكة. وقد كبح جماح التعصب والخرافات، وأقام دينًا سهلاً واضحًا قويًا، وصرحًا خلقيًا وقوامه البسالة والعزة القومية، واستطاع في قرن واحد أن ينشئ دولة عظيمة “، نعم … إنها عظمة تحتاج الأمة إلى تداركها حتى كادت الفطرة تختفي وتندثر بعدما تفلتت الأخلاق، وأصبح الإنسان غريبا عن نفسه وعن فطرته في هذه الحياة، في وقت تحول فيه الإنسان إلى آلة صماء، تدور رحاها في دوامة الماديات، ولا تلتفت إلى حقيقتها، إلا حين تحيط بها المتاعب والخطوب.