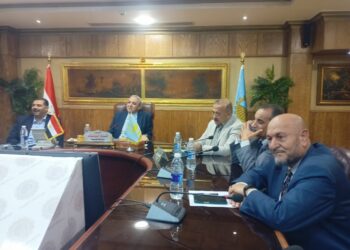الريف وجه مصر المشرق.. سمات أهله وأهم هواجسهم
بقلم/ د. أحمد علي سليمان
قريتي.. مسقط رأسي اسمها جميل.. وجَوُّها جميل.. وموقعها أجمل.. وأهلها طيبون..
اسمها (قرية بِلُوس الهوى) وهي من أعمال مركز السنطة محافظة الغربية تبعد حوالي ٦ كيلو من ميت غزال بلد الشيخ مصطفى إسماعيل…
وكانت قريتنا صغيرة عبارة عن قوس كبير فتحته ناحية اليمين تطل على الطريق الرئيسي الذي يربط بين الجعفرية ومدينة السنطة.
أما ظهر القوس فكان يطل مباشرة على نهر بحر شبين -وكانوا يطلقون عليه البحر-.. بحيث تحتضن القرية النهر (وعرضه من ٣٠ إلى ٦٠ متر تقريبا بحيث يتسع ويضيف في مناطق مختلفة) ويحتضنها هو الآخر… البيوت متراصة في مشهد بديع على حافة النهر وكأننا في مدينة أمستردام الهولندية حيث تطل البيوت على جداول المياه مباشرة.
وكانت المراكب الشراعية القديمة والمراكب المحملة بالملح والبضائع قديما تمر في النهر فضلا عن مراكب الصيد الصغرى (ذات المجادف) والتي كانت جزءا لا يتجزأ من المشهد اليومي للقرية…
ويا حظ من كان لبيته وجهتان إحداهما تطل على النهر ليرى المراكب والسواقي والحلزونات وطنابير المياه، والأخرى تطل على الطريق الزراعي ليأنس بالمارة، ويرى عربات الجاز التي يحركها حصان أو بغل أو حمار.. وكذا عربات بيع الأواني النحاسية أو الألمونيوم أو القماش أو عربات بيع القصب…إلخ..
ويا له من حظ عظيم مَن يرى سيارة ملاكي لأحد الضيوف أو الكبراء تمر على الطريق كل فترة طويلة.. ليظل يحكي قصتها ووصفها عدة أسابيع لمن لم يرها…
ولقد كان لنا منزلنا القديم في وسط القرية أما منزلنا الجديد فكانا تطل وجهته الرئيسية على الطريق الرئيسي وتطل وجهته الخلفية على النهر… ويا له من حظ عظيم…
وكانت قريتنا الصغيرة تتبع إداريا الجعفرية التي تبعد عنا حوالي كليو ونصف، والتي كانت تضم قصرا لمحمد علي باشا، ويوجد بها مقام لسيدي محمد أبو العزم الذي ينتهي نسبنا إليه ويصل بنسبنا إلى سيدنا الحسين (رضي الله عنه وأرضاه)، وتضم أيضا مقاما للقطب الصوفي الكبير العارف بالله سيدي أحمد المرسي الزرقاني (رضي الله عنهم جميعا)..
وأهم ما يميز أهل القرية الطيبة والشهامة والنخوة والترابط والكرم الحاتمي خصوصا للأغراب، وتتميز بتبادل المطعومات بين البيوت، فأهل القرية كلهم إما أقارب أو نسايب وبينهم مصاهرات على الدوام..
ومن الجميل وقتذاك أن أي إنسان غريب أو جاء من سفر أو عابر سبيل لابد أن ينال من طعام البيت الذي يدخله لأي سبب حتى ولو كان لطلب شربة ماء… ومن كان بيته على الطريق العمومي كان دائما ما يحظى بهذه المزية..
خصوصا وأن أهل القرية من طبيعة معيشتهم أنهم لا يحملون أبدا همَّ الرزق، ذلك لأن بيوتهم عامرة على الدوام بالدجاج والبط والأوز.. والماعز والخراف.. وكانت عامرة أيضا بمَتَارد الألبان -أوعية مخصوصة من الفخار- في غرف مخصصة لذلك أو في الأفران.. وكانت مليئة دوما بحصائر الجبن القريش المعلقة على الحوائط لتجفيفها من الماء ومش الحصير.. وكانت أسطح البيوت تزخر بزلعات الجبنة القديمة المُحْكمة والمش وبعضه عتيق مرَّ عليه عقود وأزمان.. فضلا عن زَلُوع خزين الحبوب والقمح على السطوح… والخبز الناشف حاضر على الدوام.. ويا لها من خيرات حسان..
فهَمّ الرزق كان غالبا ما يشغل أهل البندر أو المدينة، وما كان أبدا يشغل أهل القرية أو أهل الريف..
فإضافة إلى ما سبق كانت حياتهم قائمة على منظومة القيم الإيمانية لاسيما التوكل على الله والصبر والدعاء، وعلى بذل الجهد الرهيب في حراثة الأرض وزراعتها… يضعون البذور والشتلات ويؤمنون برب السموات.. فالإيمان بالغيب كان سيد الموقف في حياة أهل الأرياف.. فالله الذي يفطر لهم الحَّب والنوى ويُخرج لهم على الدوام من الأرض النبات والطيبات من الرزق فكانت حياتهم دوما مرتبطة بخالقهم جل وعلا..
ومن بركات أهل القرية دائما أنهم جميعا يحافظون على أداء الصلوات الخمس والنوافل ولا تجد فيهم من يتكاسل عن الصلاة… فتراهم يصلون الصلوات خصوصا الضحى والظهر والعصر في المصليات الصغيرة التي تكفي الواحدة لحوالي خمسة أشخاص على رأس الزراعات في حقولهم..
أما المغرب فكان بين بين إما يصلونه في المصليات بالحقول أو في المسجد بعد الوصول.. أما العشاء والفجر وصلاة الجمعة فكانت تتم دائما في المساجد وفي الجماعة الأولى.. فكل الناس يصلون ويذكرون.. ويصطحبون أبناءهم صغارا وكبارا للصلاة في المسجد جماعة وفي الجماعة الأولى بالذات.. ويا لها من بركة عظيمة..!!
وكان احترام الكبير سمة أهل القرية.. فالرجل الذي يركب دابته إذا رأى كبيرا جالسا أو واقفا أو ماشيا فلابد أن ينزل عن دابته حتى يمر الكبير أو يمر هو بعيدا عن الكبير ويظل يطبطب بيده اليمنى على صدره مع انحنائة يسيرة للكبير..
وكان أيّ ضيف يمر بالقرية وحده أو بصحبة أيّ من أهل القرية أو القرى المجاورة يقف الناس له إجلالا وإكبارا.. وينادونه بكلمات جليلات “تفضل عندنا بدستور الحاج فلان”..
وكان للمعلم شأن عظيم في دنيا الناس بالقرية.. فالمعلم إذا مرَّ بأهل القرية وقفوا له إكبارا.. أما التلاميذ فكانوا إذا رأوا معلما يسرعون للتخفي منه داخل البيوت.. فالمعلم كان كبيرا وكان قدوة حسنة والناس يضربون الأمثال بأقواله التي يسمعونها منه مباشرة أو في الإذاعة المدرسية التي كان صداها يصل للحقول المجاورة ويضربون الأمثال بفعاله.. وكان إذا رأى تقصيرا من أي طالب ذهب بنفسه إلى أبيه أو جده في البيت أو الحقل ويخبره بحاله واستهتاره.. ليحدث بعدها ما لا يحمد عقباه على هذا المقصر الذي يأخذ درسا حياتيا قاسيا يسير عليه مدى الحياة..
وشيخ المسجد كانت له مكانة سامقة فهو القدوة والمثال والنموذج والنبراس.. أقواله دائما ما يحفظها الصغار والكبار ويرددونها على الدوام..
وكانت الصغيرة منه تعد من كبائر الموبيقات..
كانت الناس تعيش على الفطرة وتتوكل على الله وتكثر من الصدقات والنذور..
ومن السنن الحسنة التي سنّتها والدتي -أطال الله في عمرها- أن تُخرج لبن مواشينا التي تحلب يوم الجمعة لله على الفقراء والمساكين والغرباء والأصدقاء على الدوام..
اعتقادا يقينيا منها أن ذلك يحافظ على الحيوانات، وهذه العادة مرَّ عليها أكثر من أربعين عاما..
ومن عاداتهم محبة أولياء الله الصالحين وزيارتهم وتقديم الطعام للمجاورين لهم والنذور لعمارة مساجدهم… مرة على الأقل في العام.. فكنتُ وأنا صغير أذهب مع والدتي وبعض الأقارب لزيارة سيدي إبراهيم الدسوقي في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، ونذهب لزيارة سيدي أحمد البدوي في مدينة طنطا بمحافظتنا وزيارة بعض الأقطاب والأولياء في نواحينا…
وكانت هذه الزيارات ذات طابع روحاني جليل.. وإن كانت هذه الزيارات قد توقفت منذ سنوات طويلة، إلا أنها ما تزال عاقلة في الوجدان..
وكانت حياة الريف عموما قائمة على البيع والشراء وعلى الاستيقاظ المبكر بسبب ذلك للذهاب إلى الأسواق ويعتبرون البركة -كل البركة- في البكور؛ لذلك كانوا ينامون بعد العِشاء والعَشاء، ويستيقظون قبيل صلاة الفجر عندما تشقشق العصافير..
وكان الفلاح غالبا ما يقضي طوال اليوم في حقله، ويستعين على مواجهة الجوع مؤقتا بما أفاض الله عليه من خيرات وثمار في حقله كالخيار أو الباذنجان أو الجزر أو الكرنب أو اللفت أو السريس أو الفول أو الفول السوداني أو الخس… إلخ، في حين
كانت الوجبة الرئيسية هي وجبة العَشاء مع جميع أهل البيت من الصغار والكبار وكان الصغار لهم عناية خاصة عند ربِّ البيت…
أما في أوقات الحصاد وتجمع الناس لمساعدة بعضهم البعض فكانت تنهال عليهم صواني الرز المدسوس (المعمر) ومشتملاته في الحقول وقت الغداء. وكانت السيدات تتبارى في إظهار شطارتها وطبيخها بأحسن طعم وأفضل شكل.
هذه أهم الملامح الطيبة لأهل القرية..
في حين كانت هناك أمور صعبة جدا وهواجس تؤرق أهل القرية خصوصا الصغار مثل: الجِنَّية.. وأقوال كثيرة عشنا عليها منها: “نام بدري لحسن الجِنِّية تأخذك”…
الجِنِّية هذه الأسطورة العجيبة كانت أصعب هاجس على الصبية والصغار وحتى الشباب.. “خلي بالك الجِنِّية بتطلع من البحر بالليل”؛ حتى لا يذهبوا قريبا من البحر..
الجِنِّية ذلك الكائن المرعب يخوفون بها الأشقياء لتحد من غلوائهم وإزعاجهم..
“الجِنِّية طلعت الليلة اللي فاتت وشافها عمك فلان وكانت كبيرة جدا وعاملة زي شجرة الصفصاف وكانت بتسرح شعرها بمشط كبير أد الذراعين، وبعدما خلصت نزلت البحر”..
وكنا نفكر هل الجِنِّية واحدة فقط؟ أم أن لكل مكان جِنِّية؟ وهل لها أولاد؟ وهل من الممكن أن تموت نهائيا ويخلو العالم منها؟!…
أسئلة كثيرة كانت تدور في عقولنا ونحن صغار..
أما ما كان يخيف الكبار والصغار على حد سواء هاجس الظلام الدامس -حيث لا كهرباء وقتئذ، وحتى لما دخلت الكهرباء كانت كثيرا من تنقطع لعدة أيام- وما يترتب عليه من تمكن الحرامية وعصابات سرقة المواشي من سرق مواشي أي بيت وهي رأس مال الفلاح..
وكانت فترة ما بعد العشاء إلى الفجر من أصعب الفترات على أهل كل بيت لا سيما مَن كانت بيوتهم على الطريق العمومي أو كانت نائية خصوصا في وقت الشتاء…
وللحديث بقية