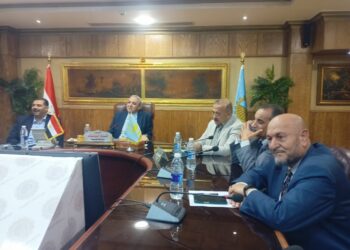تربى محمداً بين قوم يدينون له بوافر الحب وعظيم الثقة حتى لقبوه بالصادق الأمين، ودان لهم بالعرفان والامتنان، فهم الذين وقفوا لجده عبدالمطلب يمنعوه ذبح أبيه عبدالله، وكان عبدالمطلب قد نذر لئن رزقه الله بعشرة أبناء ليذبحن أحدهم قرباناً، كما فاضت قلوب بنى هاشم له حناناً ورعايةً ليُتم أصابه قبل أن يخرج للحياه، فهذا عمه أبو لهب يعتق جاريته فرحاً بمولده، وهذا جده يغمره حناناً وحباً و تكريماً بعد أن ضاعف موت أمه اليتم عليه، وذاك عمه أبو طالب نعم الكفيل بعد جده، يقدمه على ولده ويحوطه بالمَنَعَةِ والحماية طيلة حياته، فكان محمداً العشق لمكة وقومه بنى هاشم على حد سواء، عشقاً نبتت جذوره من عشقهم لأبيه عبدالله الذبيح، عشقاً أضاف له اليتم حناناً وحنواً ورعايةً، عشقاً أرسى قواعده عظم أخلاق محمد وكريم شمائله.
ورغم ذلك شب محمداً غريباً فى قومه، لوثنية كانت تغلف باطلهاً بغطاء كثيف ليسهل على العقول تجرع مرارتها، فتبتلعها النفوس على ما فيها من خبل، تقول بإلهٍ خلق ثم تتخذ حجارة آلهه وسيطة تقربهم من الإله الخالق زلفى، ثم تنسى بآلهتها الوسيطة المدعاة إلهها الحق الأصيل خالق السماوات والأرض، إن وساطة حجارة بين الإنسان وخالقة سخفاً وسفهاً بالغ السوء، وهوة سحيقة هوت بها مكة والعرب من قبل، وما زال يهوى بها الملايين من البشرية الغافلة الحائرة المعذبة، أليس من التكريم اتصال الإنسان بخالقة دون وسيط؟
وإذا جاز وسيط ألا يوجد غير الحجارة الصماء البكماء وسيطا؟ أليس من الرشد أن يوسط الإنسان أولوا الألباب والبلاغة ليحسنوا إنجاز ما يبتغيه من ملك مهاب أو وزير معظم؟ أم عميت أبصار هؤلاء وأفئدتهم فلم يجدوا غير الحجارة وسيطاً بينهم وبين خالقهم، عبدوها وخاصموا وصالحوا وذبحوا الذبائح لأجلها، ألا ساء ما سولت لهم أنفسهم، تلك العقيدة المزرية جعلت حياة محمد غربة فى وطنه وبين قومه، رغم حبهم له، وعرفانه لرعايتهم وثقتهم به، فأنكر عليهم، واعتزلهم فما شارك فى أعياد أصنامهم وكان أشد ما يبغض ذكرها أوالقسم بها، وما أكل ذبيحة ذُبِحَت لها. فإذا ما بدأ القوم فى سفه أو ضلال كان له فى العزلة صيانة لفطرته وكرامة لعقله، رغم أساه وحزنه على ما ألم بهم، غير أنه لايملك لهم صرفاً ولا عدلاً، فإذا ما اجتمعوا لخير وعزموا على رشد كان أقدمهم عليه وأسبقهم إليه، وما بناء الكعبة وحلف الفضول إلا مجامع خير كان محمداً فى طليعة العاملين الأولين لإنجازها، مبتهجاً لاجتماع قومه على الخير بهجة طبيبٍ يتماثل مريضه للشفاء، كان ذلك منهاج محمد صلوات الله عليه فى إدارة ذاته قبل البعثة ، مشاركةً سباقةً لقومه فى الخير، وعزلةً عنهم فى السفه والضلال، فلم يكن لديه رسالة ولا هدى يدعوهم إليه، فاستطاع بحسن إدارته لذاته صيانة فطرته وحفظ كرامته، وسط ظلماتٍ كثيفةٍ تموج بها الأرض من كل جانب، تطفح على البشرية شقاءً وضلالاً وتيهاً.
لم يكن يعلم حينها أنه الشمس التى ستمحوا الظلمات، والقمر الذى يبدد بأنواره ليل البشرية الطويل البهيم، لم يَدُر بخلده أنه السراج المنير الذى سينقذ البشرية من ذلك التيه الثقيل، ويأخذ بيدها ليخرجها من تلك الهاويةِ السحيقةِ يوماً ما، لتدور فى فلك أنوار نبوته مودعة عهداً بائساً مظلماً، ليبدأ على هذه الأرض عهداً جديداً، وتاريخاً مجيداً لأمه ربانية تقود البشرية بوحى السماء، ينعم فى ظلها الكون والإنسان كل الإنسان بالعدل والحرية والرحمة والكرامة، حتى يسير الراكب بين المدائن لا يخاف أحداً على نفسه وماله، فلا يخشى إلا الخالق سبحانه. ولا يليق بالأتباع غير اتباع طريقة مُعَلِمُهم ومنهاجه فى إدارة ذواتهم.
فللبشرية والأوطان والأهل منا حباً خالصاً، مبذولاً عن طيب نفسٍ ورضى، وعرفاناً صادقاً لمن مد لنا يداً بمعروفٍ يوماً ما، ولو كانت كلمةً طيبةً أو ابتسامةً ودٍ أو غيبةً ذكرنا فيها بخير، فالحر من صان وداد لحظة، فإذا ما اجتمع القوم لخير كنا من السابقين الأولين، يأبى علينا اتباع محمدٍ إلا أن نكون فى المقدمة، لا نبخل بجهدٍ يُبذَل ولا مالٍ يُنفَق، فإذا ما شاع بين القوم فساد وذاع نفاق وضربهم الشح وتقاذفتهم الأهواء يدوسون فى سبيلها كل فضيلة.
يأبى علينا كامل الإتباع لسيدنا وسابق الود لقومنا إلا أن نكون ناصحين أمناء ” إنى لكم ناصح أمين” ، وإلا فلنا فى العزلة والدعاء لهم منجاةً ونجاهً، صيانةً لفطرتنا ونقاءً لقلوبنا، ولا نزال بهم مشفقين ولهم ناصحين، نُهدِيهم دعواتنا فى سجدات الظلمات وخلوات السحر ومواطن الاستجابة، لا نَمَل ندعوا كما دعا قرةُ العين وثمرةُ الفؤاد محمداً صلوات الله عليه ” اللهم اهدى قومى فإنهم لا يعلمون”.