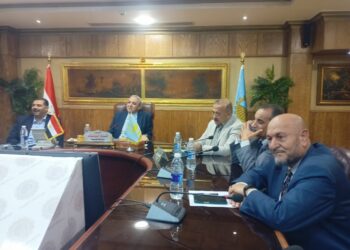مهمة ليست سهلة هو اختيار شخص من المتقدمين لشغل تلك الوظيفة من بين ستة أو سبعة علمًا بأن المتقدمين جميعهم يصلحون لشغل هذا المنصب، فهو من الأساتذة الأكفاء المشهود لهم، بل أقول إن الجامعات المصرية مليئة بمن هم يستطيعون إدارة الجامعة، ربما أكثر من المتقدمين، الذين جازفوا بسيرتهم الذاتية وحياتهم الشخصية في ظل (فبركة) الشائعات.
لكن نقطة ومن أول السطر. في السمات المطلوبة المؤهِّلة لقيادة ذلك الكيان العلمي المهمِّ ، فننظر في روايات التاريخ عن شخصية رئيس الجامعة في صورة أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد، ليتعلم رئيس الجامعة القادم أنه يكتب تاريخًا وإن انتهت فترة رئاسته، وأن الكرسي الجالس عليه دوَّار، والبناء العظيم المنوط به في سجل عمله ليس في الجغرافيا وحدها ولكن في إعداد قادة المستقبل من الطلاب والأساتذة والإداريين.
كان لطفي السيد مثالاً للإيثار والتحدي في بناء مجتمع علميٍّ جديدٍ، وقدوة في نصرة للفكر الحر والحياة الجديدة للمصريين، فحقق بطموحه الكبير مع صفوة المجتمع بناء الجامعة الأهلية (القاهرة) عام 1908م بالجهود الذاتية، دون مخصَّصاتٍ من الحكومة، وسار فوق الشوك بمفرده في ظل قيادة للبلاد لا تبالي بميزانية لتعليم أبناء الوطن.
انطلق لطفي السيد من حركة فكرية بنَّاءة في إعادة صياغة الأجيال الجديدة، لا تقوم على فكرة المناهج الدراسية وحدها ولكن في غرس قيم الولاء والانتماء، فهو آخذٌ بالمقولة (مصر للمصريين)، ومؤمنٌ بحتمية وجود الإنسان في كتابة التاريخ وتفاعله مع اختيار المستقبل الذي سيعيش فيه، وأن الإنسان هو من يصنع قدره بنفسه، فدعا إلى الحرية في الرأي، واشتهر بمقولته: (الخلاف في الرأي لا يفسد للودِّ قضية)، ولا أدل على ذلك من دعوته لكلية الآداب في تدريس الفلسفة اليونانية لبناء العقول وتوظيف الطالب للفكر المنطقي، إضافة إلى كونه مترجمًا لأرسطو.
كان واحدًا من الداعمين للكفاءات الجامعية، مشجعًا لكل يدٍ تبني وعقلٍ يفكِّر، ولكل فنانٍ يرسم لوحةً مشرقةً مشرِّفةً لبلادِهِ، يحاربُ بها جهلاً أو عنصريةً متطرِّفةً، فمن ينكر وقوفه بجوار الطالب طه حسين في بعثته لفرنسا، ودعمه له رغم قلة موارد الجامعة المالية وتعثرها، ورغم ظروف الطالب الذي يحتاج إلى نفقاته الخاصة ونفقات أخرى لرفيقٍ يأخذُ بيده، وأين منه إلى قرار شجاع يتخذ بحقِّ أعمى لم يكتب له النجاح بعدُ ليُرْسَلَ في بعثة إلى أورويا، إنه صاحب الرأي المستنير الذي يشجِّع أشخاصًا، ويبني نفوسًا ، وينهض بالجامعة لا لينفذ أغراضه ويسيء في استعمال سلطته تجاه أفراد المؤسسة.
ولا يخفى على ذاكرة التاريخ موقفه حيالَ فصل طه حسين من عمادة كلية الآداب في العام 1932م، فاعترض طه حسين -العميد حينئذٍ- على منح الدكتوراه الفخرية لبعض الشخيصات من مثل: عبد العزيز فهمي وتوفيق رفعت وعلي ماهر، ما اضطر وزير المعارف وقتئذٍ من اتخاذ قراره بنقله إلى الوزارة وتركه للعمادة، احتجَّ أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد واعتبر أن عزل طه حسين من منصبه ونقله إلى الوزارة تدخلٌ سافرٌ في شؤون الجامعة، وتقدَّم باستقالته من رئاستها، رغم أنه شارك في اتخاذ القرار، وهو منح الدكتوراه الفخرية لهؤلاء، على حسب علمي وظني بوصفه رئيسًا للجامعة، لكنه لبَّى نداء المسؤولية ومبدأ القيم الجامعية تجاه أفراد مؤسسته، والنظر بعين العدالة إلى أقدار الأشياء.
تلك أيها السادة شيمٌ مختصرة في إدارة الجامعة وامتلاك القدرة على محاورة الأزمات وإدارتها مهما كانت بالغة الصعوبة، وهذه هي العدالة في إنصاف الأفراد، والوقوف بجانبهم في أزماتهم لحظة تعثرهم، وهذا موقف الوطنيين الشرفاء بجانب وطنهم، فماذا سيستفيد الوطن إذا ظُلم أفراده أو بعضهم.
إن رئيس الجامعة منصب علمي إداري، يحتاج صاحبه إلى قدرٍ وافٍ من العلم والفن والتفكير، به يصنع إستراتيجية لجامعته، وبالجامعة يصنع منارة للمجتمع وحوارًا فاعلاً بصفة دائمةٍ مع متطلباته وخبرة في علاج مشكلاته وقدرة على استغلال إمكاناته في النهوض به، ويخطِّط لتنميةٍ مستدامةٍ للمجتمع الصَّغير الجامعة، والكبير الوطن، لكنه يبقى فردًا في منظومةٍ ضمن فريقه الذي اجتمع على قلب رجل واحدٍ، ولديهم طموح مغرِّد نحو آفاق جديدة من العلم والفن والحياة وباعث لثقافة الأمل والوطنية في مؤسسته، يحمل آمال الوطن في تحمل المسؤولية في صيد المستقبل المشرق لأبناء الوطن.